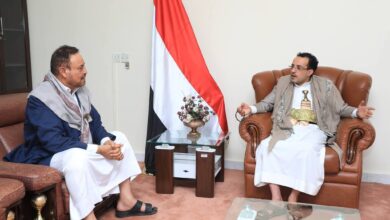فجر اليوم الاخباري|| خاص
“هرب علي سالم هرب للوحدة بدولة مفلسة ليسلم الشمال ديون خارجية على الجنوب بلغت 13 مليار!” هذه من أكثر الروايات التي رُوّج لها بعد حرب صيف 1994م لتبريرها سياسياً وأخلاقياً، الزعمُ بأن علي سالم البيض والحزب الاشتراكي “هربوا إلى الوحدة” كي يتكفّل الشمال بسداد ديون الجنوب الخارجية، وكأن الوحدة كانت عملية إنقاذ مالي لدولة مفلسة. هذه الرواية، رغم شيوعها، لا تصمد أمام التدقيق الاقتصادي.
أولى هذه المغالطات الحديث المتكرر عن ديون مزعومة على الجنوب بقيمة 13 مليار دولار قبل الوحدة. في المقابل، تُظهر الوثائق الاقتصادية الرسمية أن إجمالي الدين الخارجي القائم للجمهورية اليمنية الموحّدة بعد الوحدة بلغ نحو 6.1 مليار دولار أمريكي فقط، وفق تقرير اقتصادي رسمي صادر عام 1992 عن البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة اليمنية. هذا الرقم يشمل ديون الشطرين معاً، وهذا الرقم ينسف الادعاء بأن الجنوب وحده كان مثقلاً بديون هائلة بلغت 13 مليار دولار سددها الشمال لاحقاً. فالدولة الموحدة ورثت ديون الدولتين السابقتين معا 6مليار، ولم يتحمّل شطرٌ ديونَ الشطر الآخر!
وعند الانتقال إلى مقارنة الأداء الاقتصادي الفعلي قبل الوحدة، تتبدّد صورة “الجنوب الفقير الهارب” فعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي عام 1990، ورغم الفارق السكاني الكبير، حيث بلغ عدد سكان الشمال نحو سبعة ملايين نسمة مقابل قرابة مليونين ونصف في الجنوب، نجد أن الشمال سجّل ناتجاً محلياً إجمالياً يقدّر بحوالي 290 مليون دولار، بينما بلغ الناتج المحلي في الجنوب نحو 231 مليون دولار. هذه الأرقام، عند قراءتها في ضوء الحجم السكاني، تكشف مفارقة لافتة.
فإذا قُسِّم الناتج المحلي على عدد السكان لاحتساب متوسط الدخل السنوي للفرد، يتبيّن أن متوسط دخل المواطن في الجنوب بلغ نحو 89 دولاراً سنوياً، مقابل نحو 40 دولاراً فقط في الشمال. ورغم تواضع الرقمين معاً، إلا أن الفارق النسبي واضح، ويزداد وضوحاً إذا أُخذ بعين الاعتبار أن دولة الجنوب كانت دولة رعاية اجتماعية، تؤمّن التعليم والصحة والسكن والعمل بأسعار رمزية أو مجاناً، بينما كان المواطن في الشمال يحصل على دخل نقدي محدود ثم يضطر لشراء جميع الخدمات من السوق.
في ما يتعلّق بسعر الصرف قبل الوحدة، كان لكلٍّ من الشمال والجنوب نظام نقدي مختلف يعكس طبيعة اقتصاده وسياساته النقدية. فقد كان الدولار الواحد في الشمال يشتري في عند مستوى يقارب من 9 إلى 12 ريال. فيما كان الدينار الجنوبي يساوي 26 ريالاً شمالياً، فكان الدولار الواحد يُشتى بـ 2.6 دينار تقريباً في ذات الفترة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات.
غير أن هذا الفارق لا يدلّ بالضرورة على قوة اقتصادية حقيقية، بل على اختلاف جوهري في أنظمة الصرف؛ إذ كان الدينار عملة مدعومة سياسياً في إطار اقتصاد مُخطّط، بينما كان الريال عملة سوقية يحددها البنك المركزي وتخضع لتقلبات السوق. وعليه فإن المقارنة بين العملتين تُظهر اختلاف النماذج الاقتصادية أكثر مما تعكس تفوقاً حقيقياً لأحد الشطرين على الآخر. أما أذا أخنا الأمر بصورة شكلية بدون تحليل اقتصادي عميق، فإن الدينار كان أقوى من الريال بـ 26 مرة، لكني لا أحب مثل هذه المغالطات.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن كبار التجار في الجنوب هربوا بأموالهم من الجنوب إلى الشمال هرباً من التأميمات الاشتراكية (كان في كثير منها حماقة اقتصادية وسياسية وشطط غير علمي ولا ماركسي لم يحدث في الاتحاد السوفيتي ذاته ولا في الصين الشعبية) ما يعني أن الشمال بعد عام 1968م حصل على انتعاشه اقتصادية لم يكن للنظام أو المجتمع في الشمال يد فيها لولا المصادفة التاريخية. فيما النظام في الجنوب بعد هروب رأس المال أعاد بناء الاقتصاد من جديد ومع ذلك فقد لحق بالشمال وتفوق عليه مقارنة بالمعيار السكاني.
تُظهر هذه المعطيات أن الفوارق الاقتصادية بين الشطرين لم تكن فوارق انهيار مقابل رخاء، بل كانت أوضاعاً متقاربة في البؤس العام، مع اختلاف في الشكل لا في الجوهر. كلا الاقتصادين كان يعاني من مديونية خارجية، وكلاهما كان يعتمد على الخارج: الجنوب على المنح والدعم من دول الكتلة الاشتراكية، والشمال على تحويلات العمالة والمنح الخليجية والدعم الغربي، مع استيراد معظم الاحتياجات الغذائية الأساسية. ولم تكن الهوة بين الاقتصادين شبيهة مثلاً بالهوة التي كانت قائمة بين ألمانيا الغربية الصناعية المتقدمة وألمانيا الشرقية الاشتراكية، حيث كان الفارق بينهما حادا وحاسماً جعل المواطنين يحاولون الهروب من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية إلى درجة بناء ألمانيا الشرقية جدار فاصل لمنع الهروب، وهذا لم يكن موجوداً.
سياسياً واجتماعياً، لا يصح أيضاً تصوير الجنوب كاستثناء سلطوي مقابل شمال تعددي. فحكم الحزب الواحد في الجنوب يقابله عملياً حكم الحزب الواحد في الشمال، مضافاً إليه تحالف المشايخ والجنرالات، حيث كانت كل قبيلة بمثابة سلطة قائمة بذاتها. الاستبداد في التجربتين كان متقارباً في الجوهر، والنظام الأمني لا يرحم معارض.
أما من حيث البنية الاجتماعية، فقد عرفت تجربة الجنوب ما يمكن تسميته “اشتراكية الشحة”: عدالة نسبية ضمن سقف اقتصادي شديد المحدودية، لكن من دون فقراء بالمعنى الكلاسيكي، أي من دون جماعات لا تجد قوت يومها، لأن الدولة كانت تتكفّل بالحد الأدنى من الغذاء والعمل والسكن. لم يكن هناك تفاوت طبقي فاحش ولا ثراء متضخم في مقابل فقر مدقع، كما كان الحال في الشمال، حيث وُجدت طبقات ثرية من التجار والمشايخ في مقابل عمال وفلاحين وموظفين حكوميين يعيشون على الهامش. في الجنوب، لم تتشكّل طبقات اجتماعية استغلالية بهذا المعنى، إذ كان العمال والموظفون يعملون في إطار الدولة نفسها ويحصلون منها راتب وخدمات فلا يثرى من تعبهم أحد!
في المحصلة، لم يكن أيٌّ من الاقتصادين نموذجاً ناجحاً أو قابلاً للاستمراية: لا الجنوب نجح في بناء اشتراكية صناعية منتجة، ولا الشمال أسّس رأسمالية صناعية وطنية. كان كلاهما اقتصاداً مأزوماً، وهو ما جعل الوحدة ضرورة اقتصادية موضوعية للطرفين من حيث المبدأ، بهدف توحيد الموارد والقوى العاملة والثروات الكامنة، لا عملية إنقاذ طرفٍ لطرف. غير أن هذه الضرورة لم تُترجم إلى مشروع دمج اقتصادي عقلاني، بل جرى لاحقاً حسمها بالقوة وإعادة إنتاج الاختلالات بشكل أعمق فبعد 1994 ارتفعت الديون وانهارت العملة وتعمق الفقر جنوباً وشمالاً.
أما الخلاصة الأساسية، فهي أن القول إن الاشتراكي والجنوب ذهبا إلى الوحدة هرباً من الديون هو تبسيط دعائي يتجاهل المعايير الاقتصادية المعتمدة عالمياً في قياس قوة الاقتصادات، ويتغاضى عن حقيقة أن الدولة الموحدة حملت ديون الشطرين معاً.